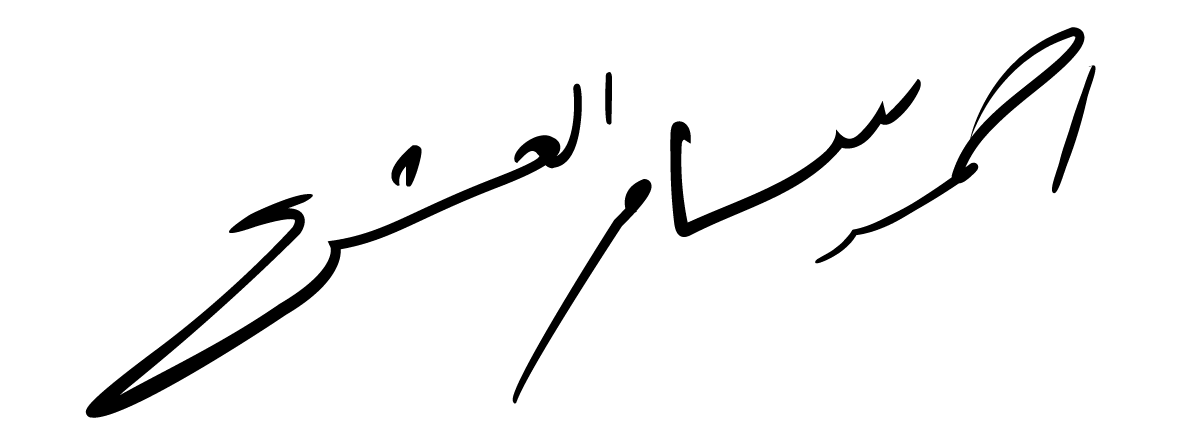المثليةُ، المخدرات، التيك توك، السلفي، اللطم، المقدسات الزائفة، أصناف الطعام الفاخرة، الأصنام البشرية من (قادة، فنانين، قديسين، رجال دين ….)، صورٌ مبعثرةٌ على الانستغرام، لقطاتٌ لطيفةٌ لسرقة ضحكاتٍ عابرة، ضحكاتٌ شريرةٌ، ابتساماتٌ ساخرةٌ لسياسي في مؤتمر صحفي، أيديولوجياتٌ عابرةٌ تُخفي الشرَّ البشريَّ المنفلتَ من عقاله ……
في المقابل خيمةٌ، جوعٌ، ألمٌ، يأسٌ، وحلٌ، وابتساماتٌ عبثيةٌ مطحونةٌ، أقدامٌ صغيرةٌ عاريةٌ مغطاةٌ بالطين، بائعٌ متجولٌ صغيرٌ يستجدي الإنسانيةَ في النظرات العابرةِ، بحثٌ عابثٌ عن بيت، عملٌ، مدرسةٌ، وروحٌ وهويةٌ يختصرها بعضُهم بكلمة وطنٍ وجوازِ سفر …..
حربٌ منظمةٌ قذرةٌ هدفُها انتقامٌ أعمى من عيونٍ زرقاءَ وذكاءٍ اصطناعيٍّ، وصاروخٌ ذكيٌّ، وأحيانًا فيروس لا يُرى بالعين المجردة…..
إغراقُ أحلامِ أطفال المستقبل في دماء أريقت منذ 1342 سنة، وعباءةٌ سوداءُ تقودُ ثيرانًا تتدافع إلى المسلخ الأبدي، وشيطانٌ يفتح البابَ مبتسمًا، وقد حققَ جزءًا من حلمه الأبديِّ بذبح أكبرِ عددٍ من هذا الجنسِ الجاهل الأعمى.
خزنةُ خائنٍ شجع ومُخَدَر امتلأت حتى اضطر ليحشر العملاتِ الورقيةَ الزائفةَ في بطنه، أفيونٌ داخلي لا ينتجه إلّا كرسيُّ التحكم بمصائر الآخرين..
ملايينُ الإعلانات تُسوِّقُ لتلك المشاهدِ، واللقطاتِ العابرة لتبقيَ المغيَّبَ مخدرًا، وتجلب أعدادًا جديدة من الضحايا تحت وطأة الحاجة البشرية والعزلة والخوف الأبدي مما هو قادم.
في الشرق الأوسط وقعت تلك العناقيدُ الاجتماعيةُ بين عدوين شرسين؛ الغربِ الليبرالي المدفوعِ بذهنية السيدِ المستعلي الأبيضِ المسلحِ بالعلم والقفازاتِ البيضاءِ وسلاحِ النشوة الموجهِ لاستعباد الجسدِ والروح، وبين الشرقِ الأكثرِ شراسةً وإجرامًا، والأقلِّ تخطيطًا وعلمًا، الذي يستخدم سلاحَ الأسطورة والخرافة، ويحاولُ دفنَ عقدةِ النقصِ لديه بين أجسادنا المثخنةِ من آلة إجرامه …
قد يكون سلاحُ الأخير أشدَّ أذىً جسديًّا وأسرعَ فتكًا من سلاح العدوِّ الأول، لكنَّ سلاحَ العدوِّ الأولَ يرتكزُ على الإيذاء النفسي والعقلي والروحي أكثر، فيجعل منك إمّا عبدًا أبديًّا، أو سجينًا أبديًّا لإعلاناته الزائفة..
مازال العدوُّ القادمُ من الشرق يفكر بالطاقة والغذاء والمخدرات والصاروخ الأشدِ فتكًا، بينما انتقل العدو الأولُ لمستوى جديدٍ من ترسانة الأسلحة الشيطانية، وأوكل مهمةَ السلاح الأولِ للصديق العدو (الذي جعله شرطيًا خادمًا لمناطق نفوذه)، بين روسيا والصين والهند وإيران من جهة، والغرب الأنجلوسكسوني في تحالفه مع الملكيات الأوروبية وسلالات المال القديمة والجديدة من جهة أخرى، يبدو الفرقُ جليًا بأنّ الشرقَ عدوٌّ مقلدٌ هشٌ بنيويًا، يدور حول أفراد أسيرة للتاريخ والأساطير والدين وجنون العظمة، أمّا الغرب فهو عدوٌّ أصيلٌ عنده مراكزُ أبحاثٍ للسيطرة على البشر، تقودُها مؤسساتٌ عريقة لا تخضع لهوى أفرادٍ عابرين ونزواتهم.
نشرُ المخدرُ سلاحٌ قذر، لكنَّ نشرَ المثليةِ أقذر، الصاروخُ والبرميل قاتلٌ ومدمرٌ، لكن أن تظلَّ مؤسسةً لا تعلم عنها، تعيِّنُ وتعزلُ من يحكمُك، ويتحكمُ بمصيرِك ومصيرِ أحفادِك فهذا مدمرٌ أكثر، أن تدفعَ المالَ لتشييع فقيرٍ معدمٍ محتاجٍ، أسلوبٌ قذرٌ، لكن أن تجعلَ الجيلَ بالكامل يقتنعُ أنّ الأخلاقَ والدينَ والحياةَ لا تُقيَّمُ إلا بميزان المتعة والتمحور حول الذات أسلوبٌ أقذرُ وأخطر .أن تجعلَ رغيفَ الخبز، وتدفئةَ الشتاء، وقطرة الماء، مرهونةً بركوعك للحاكم الظالم، سلاحٌ قذر ،لكن أن تبرمج البشرَ لتؤمن أنّ الحاكمَ هو أفضلُ وأسلمُ خيارٍ، و أن نُبرمجَ لنكون عبيدًا راضين في بلادنا فهو مخطط أقذرُ.
هناك حربُ مخدراتٍ وحروبٌ دينيةٌ، وحروبُ تجويعٍ، وحروبُ تهجيرٍ وتغييرٍ ديمغرافي، وحروبُ طاقةٍ، وحروبُ تدميرٍ للبشر والحجر، كلُّ تلك الحروبِ وغيرها أوكلها الغربُ الليبراليُّ لوكلاء إقليميين يبحثون لاهثين عن دواء ناجعٍ لعقدة الدونية تجاه المستعلي الأبيض السيد، لكن ماذا عن حرب الأخلاق التي تريد استبدال منظوماتِ الأخلاقِ المتراكمة عبر قرون بمنظومة أخلاقٍ، يتحكم بها سبعة عشر قاضيًا في المحكمة الدستورية العليا الأمريكية منذ 1789 م ومن وراءهم ماكيناتُ شرٍّ عملاقةٌ تفرض على البشرية جمعاء ما هو أخلاقي وما هو لا أخلاقي …
المحكمةُ الدستورية العليا في أمريكا حكمت في قضية “غريسولد ضد كونيتيكت”، الصادر في عام 1965 والذي أقر حق الأزواجِ في الحصول على موانع الحمل، وأيضًا حكمت في قضية “لورنس ضد تكساس” في عام 2003، والذي منح الحق في الانخراط في أفعال جنسية خاصة، وحكمت 2015 في قضية “أوبيرجفيل ضد هودجز” الذي ينص على حق زواج المثليين. في 1973، أصدرتِ المحكمةُ العليا في ختام نظرِها في قضية “رو ضدّ ويد” حُكمًا شكّل سابقةً قضائيةً؛ إذ إنه كفل حقَّ المرأةِ في أن تنهيَ طوعًا حملها ما دام جنينُها غيرَ قادرٍ على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، لتعود بعد 49 عامًا لتلغيه بعد أن أجهض قانونيًا ملايين الأطفال….
حربُ الأخلاق التي خسرناها منذ أن رضينا أن تكون أخلاقُنا تبعًا لأخلاق المنتصرِ والمتغلب بالقوة، وليست تبعًا لما أنزله اللهُ ودرجت أعرافُ قومِنا على أنه أخلاقيٌّ بما لا يتعارض مع تعاليم الخالق، عند هذه المرحلة لم نعدْ نستحق القتل على يد أولئك، بل أوكلوا المهامَ القذرة ظاهريًا لغيرهم … كما هو ديدنُ العصابات وقطاعِ الطرق، فالقتلُ الجسديُّ يوكلونه لزبانيتهم، أمّا هم فيتفرغون لما هو أعظمُ وأمكرُ وأخطرُ…
يتحدثون الآن عن المثلية والمنتجات المنتشرة بين أيدي أبناءنا والإعلانات والترويج لكل ما هو فاسد ومفسد ويدقون ناقوس الخطر!… نعم استيقظنا بعد سبع سنوات!… بعد أن أصبحتِ المثليةُ تدق أبواب بُيُوتنا بعد أن كانت لسنوات مدعاةً للتندر والضحك في صالوناتنا الفكرية ومقاهينا الشعبية …بينما كان أعداؤنا يحيكون الخطط المدروسة لذلك الغزو…!
بين شطر بيت المتنبي “من يهن يسهل الهوان عليه” وبين مقولة سيدتِنا أسماءَ ذات النطاقين “الشاة المذبوحة لا يؤلمها السلخ” ضاعت أجيالُنا؛ ربما لأنّ شيوخَ العالم الإسلامي لم يقاربوا المسائل من هذا المنظور، فلم يقدموا أجوبةً لمسائل الشهوة الجنسية والمتع الجسدية والنفسية، والتعدد، وإيجاد وسائلَ حقيقيةٍ لبناء أُسَرٍ سليمة… بل اكتفوا بالظاهر …فاستهلكوا الوقت في مسائل التعدد أهي أصلٌ أم غيرُ أصل وقس على ذلك …..
حربُ الأخلاق سلاحُها ليس بالاكتفاء في معالجة الظواهر، بل التعمقِ في فلسفة الحياة والشهوات، ووضعِ تعاليم الخالق جلّ في علاه في البيئات شديدة التغيير، وهنا دور النخب الدينية والفكرية، وإلا ستكون سنةُ الاستبدالِ قادمةً لا محالة.
واللهُ من وراء القصد